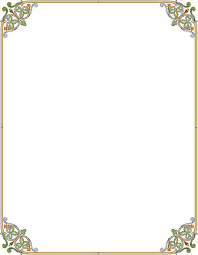كتاب الكفارات أحكام وضوابط
[مقدمة] الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله، وصحبه، والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد: فإن من رحمة الله تعالى بعباده أن شرع لهم من التعاليم والتشريعات ما يضبط تصرفاتهم ويقيم شؤون حياتهم، ويضمن لهم حياة كريمة، يسعدون بها في الدنيا، ويفوزون بالنعيم المقيم في الأخرى. ولقد حث الله عباده ورغبهم بالامتثال لأوامره، والابتعاد عن محارمه فإن ذلك هو أزكى لهم، وأصلح لشؤونهم، ولما كان الإنسان ضعيفًا، ولا ينفك عن الخطأ والزلل، وهو يرجو أن يُغفر ذنبه، ويُكفر عن سيئاته، ويُعفى عن خطئه، بحيث يخرج من الدنيا وقد خفف عن ظهره ما استطاع من الأثقال التي تعرضه للحساب يوم القيامة، فقد جعل الله له في كل أزمة مخرجاً، ومن كل ذنب فتح له للتوبة بابًا، تحقيقاً لمبدأ الرحمة، والتيسير ورفع الحرج، ومن هذه المخارج التي جاءت بها الشريعة الإسلامية جبراً للخلل في بعض الأمور وتكفيراً للخطأ فيها، وزجراً عن العودة لمثلها فيما يستقبل من الأيام، الكفارات والتي تعد نظاماً تشريعياً رائداً لا نظير له، فهي عبادة لله تعالى تتحقق فيها التقوى المتمثلة بصدق الوفاء بها طاعة لله، وامتثالاً لأمره من غير رقيب سوى الشعور بالمسؤولية أمام الله تعالى، وهي نظام أخلاقي تتجلى فيه معاني المواساة، والتكافل الاجتماعي. ولما كانت الكفارات متعددة الأبواب مختلفة الأحكام في بعض تفاصيلها، وكون الحاجة إليها ماسة لعموم البلوى بها، وشدة حاجة المجتمع إليها فقد رأيت أن أكتب في هذا الباب المسائل المتعلقة بالكفارات محاولاً التركيز على القضايا المهمة فيها والتي تقتضي المعرفة لدى الجمهور، وسميته (الكفارات ... أحكام وضوابط) وقد اقتضى البحث تناوله وفق الخطة التالية: التمهيد، ويشتمل على ستة مطالب: المطلب الأول: تعريف الكفارة. المطلب الثاني: الحكمة من تشريع الكفارات. المطلب الثالث: الحكم التكليفي للكفارات. المطلب الرابع: الفرق بين الكفارة والفدية. المطلب الخامس: هل الكفارات عقوبات أم جوابر؟ المطلب السادس: الأفعال التي توجب الكفارة. الفصل الأول: كفارة اليمين، ويشتمل على خمسة مباحث: المبحث الأول: تعريف اليمين، ومشروعيتها. المبحث الثاني: أقسام اليمين. المبحث الثالث: خصال كفارة اليمين. المبحث الرابع: أحكام كفارة اليمين. المبحث الخامس: مشبهات اليمين. الفصل الثاني: كفارة الظهار، ويشتمل على مبحثين: المبحث الأول: تعريف الظهار، وحكمه. المبحث الثاني: خصال كفارة الظهار، وأحكامها. الفصل الثالث: كفارة القتل، ويشتمل على ثلاثة مباحث: المبحث الأول: أقسام القتل، وما يوجب منه الكفارة. المبحث الثاني: خصال كفارة القتل. المبحث الثالث: أحكام كفارة القتل. الفصل الرابع: كفارة الجماع في نهار رمضان، ويشتمل على مبحثين: المبحث الأول: موجب الكفارة في نهار رمضان المبحث الثاني: أحكام كفارة الجماع في نهار رمضان. الفصل الخامس: كفارة قتل المُحرِم للصيد، ويشتمل على مبحثين: المبحث الأول: قتل الصيد الموجب للكفارة. المبحث الثاني: خصال كفارة قتل المُحرم للصيد. الفصل السادس: أحكام عامة في الكفارات، ويشتمل على سبعة مباحث: المبحث الأول: حكم إخراج القيمة في الكفارات. المبحث الثاني: النيابة في الكفارات. المبحث الثالث: التوكيل في إخراج وتوزيع الكفارات. المبحث الرابع: نقل الكفارة إلى خارج البلد. المبحث الخامس: حكم إعطاء الكفارات لغير المسلمين المبحث السادس: الكفارة بين الفور والتراخي. المبحث السابع: سقوط الكفارة. خاتمة.عبدالرقيب صالح الشامي - عبد الرقيب صالح الشامي، 1981‒ إمام بوزارة الأوقاف الشئون الإسلامية بدولة الكويت — باحثا شرعيا في المراقبة الثقافية بإدارة مساجد محافظة الفروانية دكتوراه في (أصول الفقه) من كلية الشريعة والقانون عن رسالة مطبوعة بعنوان: (الحكم الشرعي بين النظرية والتطبيق)❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ الكفارات أحكام وضوابط ❝ الناشرين : ❞ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت ❝ ❱
من كتب الفقه العام الفقه الإسلامي - مكتبة كتب إسلامية.

قراءة كتاب الكفارات أحكام وضوابط أونلاين
معلومات عن كتاب الكفارات أحكام وضوابط:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله، وصحبه، والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:
فإن من رحمة الله تعالى بعباده أن شرع لهم من التعاليم والتشريعات ما يضبط تصرفاتهم ويقيم شؤون حياتهم، ويضمن لهم حياة كريمة، يسعدون بها في الدنيا، ويفوزون بالنعيم المقيم في الأخرى.
ولقد حث الله عباده ورغبهم بالامتثال لأوامره، والابتعاد عن محارمه فإن ذلك هو أزكى لهم، وأصلح لشؤونهم، ولما كان الإنسان ضعيفًا، ولا ينفك عن الخطأ والزلل، وهو يرجو أن يُغفر ذنبه، ويُكفر عن سيئاته، ويُعفى عن خطئه، بحيث يخرج من الدنيا وقد خفف عن ظهره ما استطاع من الأثقال التي تعرضه للحساب يوم القيامة، فقد جعل الله له في كل أزمة مخرجاً، ومن كل ذنب فتح له للتوبة بابًا، تحقيقاً لمبدأ الرحمة، والتيسير ورفع الحرج، ومن هذه المخارج التي جاءت بها الشريعة الإسلامية جبراً للخلل في بعض الأمور وتكفيراً للخطأ فيها، وزجراً عن العودة لمثلها فيما يستقبل من الأيام، الكفارات والتي تعد نظاماً تشريعياً رائداً لا نظير له، فهي عبادة لله تعالى تتحقق فيها التقوى المتمثلة بصدق الوفاء بها طاعة لله، وامتثالاً لأمره من غير رقيب سوى الشعور بالمسؤولية أمام الله تعالى، وهي نظام أخلاقي تتجلى فيه معاني المواساة، والتكافل الاجتماعي.
ولما كانت الكفارات متعددة الأبواب مختلفة الأحكام في بعض تفاصيلها، وكون الحاجة إليها ماسة لعموم البلوى بها، وشدة حاجة المجتمع إليها فقد رأيت أن أكتب في هذا الباب المسائل المتعلقة بالكفارات محاولاً التركيز على القضايا المهمة فيها والتي تقتضي المعرفة لدى الجمهور، وسميته (الكفارات ... أحكام وضوابط) وقد اقتضى البحث تناوله وفق الخطة التالية:
التمهيد، ويشتمل على ستة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الكفارة.
المطلب الثاني: الحكمة من تشريع الكفارات.
المطلب الثالث: الحكم التكليفي للكفارات.
المطلب الرابع: الفرق بين الكفارة والفدية.
المطلب الخامس: هل الكفارات عقوبات أم جوابر؟
المطلب السادس: الأفعال التي توجب الكفارة.
الفصل الأول: كفارة اليمين، ويشتمل على خمسة مباحث:
المبحث الأول: تعريف اليمين، ومشروعيتها.
المبحث الثاني: أقسام اليمين.
المبحث الثالث: خصال كفارة اليمين.
المبحث الرابع: أحكام كفارة اليمين.
المبحث الخامس: مشبهات اليمين.
الفصل الثاني: كفارة الظهار، ويشتمل على مبحثين:
المبحث الأول: تعريف الظهار، وحكمه.
المبحث الثاني: خصال كفارة الظهار، وأحكامها.
الفصل الثالث: كفارة القتل، ويشتمل على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: أقسام القتل، وما يوجب منه الكفارة.
المبحث الثاني: خصال كفارة القتل.
المبحث الثالث: أحكام كفارة القتل.
الفصل الرابع: كفارة الجماع في نهار رمضان، ويشتمل على مبحثين:
المبحث الأول: موجب الكفارة في نهار رمضان
المبحث الثاني: أحكام كفارة الجماع في نهار رمضان.
الفصل الخامس: كفارة قتل المُحرِم للصيد، ويشتمل على مبحثين:
المبحث الأول: قتل الصيد الموجب للكفارة.
المبحث الثاني: خصال كفارة قتل المُحرم للصيد.
الفصل السادس: أحكام عامة في الكفارات، ويشتمل على سبعة مباحث:
المبحث الأول: حكم إخراج القيمة في الكفارات.
المبحث الثاني: النيابة في الكفارات.
المبحث الثالث: التوكيل في إخراج وتوزيع الكفارات.
المبحث الرابع: نقل الكفارة إلى خارج البلد.
المبحث الخامس: حكم إعطاء الكفارات لغير المسلمين
المبحث السادس: الكفارة بين الفور والتراخي.
المبحث السابع: سقوط الكفارة.
خاتمة.
للكاتب/المؤلف : عبدالرقيب صالح الشامي .
دار النشر : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت .
سنة النشر : 2018م / 1439هـ .
عدد مرات التحميل : 10749 مرّة / مرات.
تم اضافته في : الإثنين , 10 سبتمبر 2018م.
حجم الكتاب عند التحميل : 9.2 ميجا بايت .
تعليقات ومناقشات حول الكتاب:
الكفارات أحكام وضوابط
الكفارات ( أحكام ــ وضوابط )
تأليف الدكتور/ عبدالرقيب صالح الشامي
رقم الإيداع بمرگز التخطيط والمعلومات
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
2018/2 م
حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
1439 ه - 2018 م
فهرست مگتبة الگويت الوطنية
1813 - رقم الإيداع والترقيم الدولي: 2017
ISBN: 978 - 99966 - 986 - 7 - 5
نبذة عن موضوع الكتاب :
قوله: "ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضررًا بينًا..." إلى قوله: "ولا يجزئ من البُرِّ أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين، وإن غدَّى المساكين أو عشَّاهم لم يجزئه"[1].
قال في "المقنع": "والمخرج في الكفَّارة ما يجزئ في الفِطرة وفي الخبز روايتان[2]، فإن كان قوت بلده غير ذلك أجزأه منه؛ لقول الله تعالى: ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ [المائدة: 89].
وقال القاضي: لا يجزئه، ولا يجزئ من البُر أقل من مُدٍّ، ولا من غيره أقل من مدين، ولا من الخبز أقل من رطلين بالعراقي إلا أن يعلم أنه مد، وإن أخرج القيمة أو غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه[3]، وعنه[4]: يجزئه"[5].
قال في "الحاشية": "قوله: "والمخرج في الكفارة ما يجزئ في الفطرة" وهو البر والشعير والتمر والزبيب ونحوها، سواء كان قوت بلده أو لم يكن، وإخراج الحب[6] أفضل عند المصنف، والمذهب[7] أن التمر أفضل.
قوله: "وفي الخبز روايتان".
إحداهما[8]: لا يجزئ وهو المذهب، وبه قال الشافعي[9]؛ لأنه خرج عن الكمال والادخار أشبه الهريسة.
والثانية[10]: يجزئ، اختاره الخرقي، والقاضي وأصحابه، والمصنف.
قال في "الإنصاف"[11]: وهو الصواب؛ لقوله تعالى: ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾، والخبز من أوسط ما يطعم أهله.
فائدتان:
الأولى: السويق كالخبز خلافًا ومذهبًا.
الثانية: لا تجزئ الهريسة ونحوها؛ لخروجها عن الاقتيات المعتاد إلى حيز الإدام.
قوله: "فإن كان قوت بلده غير ذلك أجزأه منه؛ لقول الله تعالى: ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾، وبه قال الشافعي[12]، واختاره ابو الخطاب. والمصنف، قال في "الإنصاف": وهو الصواب[13].
وقال القاضي: لا يجزئه وهو المذهب[14]؛ لأن الخبر ورد بإخراج هذه الأصناف في الفطرة، فلم يجز غيره.
قوله: "ولا يجزئ من البر أقل من مد..." إلى آخره، هذا المذهب[15].
وممن قال: مدُّ بُر: زيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر[16] رواه عنهم الأثرم، وعن عطاء، وسليمان بن موسى، وقال سليمان بن يسار: أدركتُ الناس إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مُدًا من الحنطة بالمد الأصغر مُد النبي صلى الله عليه وسلم[17].
وقال أبو هريرة: يطعم مدًا من أي الأنواع كان، وبه قال عطاء، والأوزاعي، والشافعي[18]؛ لما روى أبو داود بإسناده عن أوس ابن أخي عبادة بن الصامت: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه - يعني المظاهر - خمسة عشر صاعًا من شعير إطعام ستين مسكينًا[19].
وقال مالك[20]: لكل مسكين مُدان من جميع الأنواع.
وممن قال: مُدَّان من قمح: مجاهد[21]، وعكرمة، والشعبي[22]، والنخعي[23].
وقال الثوري وأصحاب الرأي[24]: من القمح مُدَّان، ومن التمر والشعير صاع لكل مسكين؛ لقوله عليه السلام في حديث سلمة بن صخر: "فأطعم وسقًا من تمر" رواه أحمد وأبو داود وغيرهما[25].
وعن ابن عباس قال: كفَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر الناس، فمن لم يجد فنصف صاع من بُر. رواه ابن ماجه[26].
ولنا ما روى أحمد: حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب عن أبي يزيد المدني قال: جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمظاهر: "أطعم هذا؛ فإن مدي شعير مكان مدِّ بُر"[27]، وهذا مرسل؛ لأن أبا يزيد تابعي، ولأنه قول زيد وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة، ولم نعرف لهم من الصحابة مخالفًا فكان إجماعًا.
وعلى أنه نصف صاع من التمر والشعير ما في حديث أوس بن الصامت أنه عليه السلام قال: "إني سأعينه بعرق من تمر"، قلت: يا رسول الله، فإني سأعينه بعرق آخر، قال: "أحسنت، اذهبي فأطعمي عنه ستين مسكينًا، وارجعي إلى ابن عمك"[28].
روى أبو داود عن أبي سلمة أنه قال: العرق زنبيل يأخذ خمسة عشر صاعًا، فالعرقان ثلاثون صاعًا، لكل مسكين نصف صاع[29].
وأوجب الشيخ تقي الدين أوسطه قدرًا ونوعًا مطلقًا بلا تقدير.
قوله: "وإن أخرج القيمة..." إلى آخره، فيه مسألتان:
الأولى: إذا أخرج القيمة لم يجزئه وهو المذهب[30]، وبه قال مالك[31]، والشافعي[32]، وابن المنذر[33]، وهو الظاهر من قول عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما.
وأجازه الأوزاعي وأصحاب الرأي[34]، والأول المذهب[35] للآية، ومن أخرج القيمة لم يطعمهم.
الثانية: إذا غدَّى المساكين أو عشاهم لم يجزئه، وهو المذهب[36] سواء فعل ذلك بالقدر الواجب أو أقل أو أكثر، ولو غدى كل واحد بمُد لم يجزئه إلا أن يُملكه إياه، وهذا مذهب الشافعي[37].
وعن أحمد[38]: يجزئه إذا أطعمهم القدر الواجب لهم، وهو قول النخعي وأبي حنيفة[39]، واختاره الشيخ تقي الدين[40] إلا أنه لم يعتبر القدر الواجب، وأطعم أنس في فدية الصيام.
قال أحمد: أطعِم شيئًا كثيرًا وضع الجفان، وذلك لقول الله تعالى ﴿ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ﴾، وهذا قد أطعمهم، فينبغي أن يجزئه كما لو ملكهم[41]" .
وقال ابن رشد: "والنظر في كفارة الظهار في أشياء:
منها: في عدد أنواع الكفارة وترتيبها وشروط كل نوع منها - أعني: الشروط المصححة- ومتى تجب كفارة واحدة؟ ومتى تجب أكثر من واحدة؟
فأما أنواعها: فإنهم أجمعوا على أنها ثلاثة أنواع: إعتاق رقبة، أو صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينًا[42].
وأنها على الترتيب، فالإعتاق أولًا، فإن لم يكن فالصيام، فإن لم يكن فالإطعام، هذا في الحُرِّ.
واختلفوا في العبد: هل يكفر بالعتق أو الإطعام؟ بعد اتفاقهم أن الذي يبدأ به الصيام -أعني: إذا عجز عن الصيام- فأجاز للعبد العتق إن أذن له سيده: أبو ثور وداود[43]، وأبى ذلك سائر العلماء.
وأما الإطعام فأجازه له مالك[44] إن أطعم بإذن سيده، ولم يجز ذلك أبو حنيفة[45] والشافعي[46].
ومبنى الخلاف في هذه المسألة: هل يملك العبد أو لا يملك؟
وأما اختلافهم في الشروط المصححة فمنها: اختلافهم إذا وطئ في صيام الشهرين، هل عليه استئناف الصيام أم لا؟
فقال مالك[47] وأبو حنيفة[48]: يستأنف الصيام إلا أن أبا حنيفة شرط في ذلك العمد، ولم يفرق مالك بين العمد في ذلك والنسيان.
وقال الشافعي[49]: لا يستأنف على حال.
وسبب الخلاف: تشبيه كفارة الظهار بكفارة اليمين، والشرط الذي ورد في كفارة الظهار -أعني: أن تكون قبل المسيس- فمن اعتبر هذا الشرط قال: يستأنف الصوم، ومن شبهه بكفارة اليمين قال: لا يستأنف؛ لأن الكفارة في اليمين ترفع الحنث بعد وقوعه باتفاق[50].
ومنها: هل من شرط الرقبة أن تكون مؤمنة أم لا؟
فذهب مالك[51] والشافعي[52]: إلى أن ذلك شرط في الإجزاء.
وقال أبو حنيفة[53]: يجزئ في ذلك رقبة الكافر، ولا يجزئ عندهم إعتاق الوثنية والمرتدة.
دليل الفريق الأول: أنه إعتاق على وجه القربة، فوجب أن تكون مسلمة، وأصله الإعتاق في كفارة القتل.
وربما قالوا: إن هذا [ليس] من باب القياس، وإنما هو من باب حمل المطلق على المقيد، وذلك أنه قيَّد الرقبة بالإيمان في كفارة القتل، وأطلقها في كفارة الظِّهار، فيجب صرف المطلق إلى المقيد، وهذا النوع من حمل المطلق على المقيد فيه خلاف، والحنفية لا يجيزونه، وذلك أن الأسباب في القضيتين مختلفة.
وأما حجة أبي حنيفة: فهو ظاهر العموم، ولا معارضة عنده بين المطلق والمقيد، فوجب عنده أن يحمل كل على لفظه.
وأما حجة أبي حنيفة: فهو ظاهر العموم، ولا معارضة عنده بين المطلق والمقيد، فوجب عنده أن يحمل كل على لفظه.
ومنها: اختلافهم هل من شرط الرقبة أن تكون سالمة من العيوب أم لا؟ ثم إن كانت سليمة، فمِن أي العيوب تشترط سلامتها؟
فالذي عليه الجمهور[54] أن للعيوب تأثيرًا في منع إجزاء العتق.
وذهب قوم إلى أنها ليس لها تأثير في ذلك.
وحجة الجمهور: تشبيهها بالأضاحي والهدايا؛ لكون القُربة تجمعها.
وحجة الفريق الثاني: إطلاق اللفظ في الآية، فسبب الخلاف: معارضة الظاهر لقياس الشبه.
والذين قالوا: إن للعيوب تأثيرًا في مَنع الإجزاء، اختلفوا في عيب عيب مما يعتبر في الإجزاء أو عدمه.
أما العمى وقطع اليدين أو الرِّجلين فلا خلاف عندهم في أنه مانع للإجزاء، واختلفوا فيما دون ذلك، فمنها: هل يجوز قطع اليد الواحدة؟
أجازه أبو حنيفة[55]. ومنعه مالك[56] والشافعي[57].
وأما الأعور:
فقال مالك[58]: لا يجزئ.
وقال عبد الملك: يجزئ.
وأما الأقطع الأذن:
فقال مالك[59]: لا يجزئ.
وقال أصحاب الشافعي[60]: يجزئ.
وأما الأصم: فاختلف فيه في مذهب مالك، فقيل[61]: يجزئ، وقيل[62]: لا يجزئ.
وأما الأخرس: فلا يجزئ عند مالك[63]، وعن الشافعي في ذلك قولان[64].
أما المجنون: فلا يجزئ.
أما الخصي: فقال ابن القاسم[65]: لا يعجبني الخصي.
وقال غيره: لا يجزئ.
وقال الشافعي[66]: يجزئ.
وإعتاق الصغير جائز في قول عامة فقهاء الأمصار، وحُكي عن بعض المتقدمين منعه.
والعرج الخفيف في المذهب[67] يجزئ.
وأما البيِّن العرج فلا.
والسبب في اختلافهم: اختلافهم في قدر النقص المؤثر في القربة، وليس له أصل في الشرع إلا الضحايا، وكذلك لا يجزئ في المذهب[68] ما فيه شركة أو طرف حرية كالكتابة والتدبير؛ لقوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [المجادلة: 3] والتحرير هو ابتداء الإعتاق، وإذا كان فيه عقد من عقود الحرية كالكتابة كان تنجيزًا لا إعتاقًا، وكذلك الشركة؛ لأن بعض الرقبة ليس برقبة.
وقال أبو حنيفة[69]: إن كان المكاتب أدَّى شيئًا من مال الكتابة لم يجز، وإن كان لم يؤد جاز.
واختلفوا هل يجزئه عتق مدبره؟.
فقال مالك[70]: لا يجزئه، تشبيهًا بالكتابة؛ لأنه عقد ليس حله.
وقال الشافعي[71]: يجزئه.
ولا يجزئ عند مالك[72] إعتاق أم ولده، ولا المعتق إلى أجل مسمى. أما عتق أم الولد؛ فلأن عقدها آكد من عقد الكتابة والتدبير بدليل أنهما قد يطرأ عليهما الفسخ، أما في الكتابة: فمن العجز عن أداء النجوم.
وأما في التدبير: فإذا ضاق عنه الثلث.
وأما العتق إلى أجل: فإنه عقد عتق لا سبيل إلى حلّه.
واختلف مالك والشافعي مع أبي حنيفة في إجزاء عتق من يعتق عليه بالنسب:
فقال مالك[73] والشافعي[74]: لا يجزئ عنه.
وقال أبو حنيفة[75]: إذا نوى به عتقه عن ظِهار أجزأ.
فأبو حنيفة شبهه بالرقبة التي لا يجب عتقها، وذلك أن كل واحدة من رقبتين غير واجب عليه شراؤها، وبذل القيمة فيها على وجه العتق، فإذا نوى بذلك التكفير جاز.
والمالكيةُ والشافعيةُ رأت أنه إذا اشترى من يعتق عليه عتق عليه من غير قصد إلى إعتاقه فلا يجزئه.
فأبو حنيفة أقام القصد للشراء مقام العتق، وهؤلاء قالوا: لا بُد أن يكون قاصدًا للعتق نفسه، فكلاهما يسمى معتقًا باختياره، ولكن أحدهما معتق بالاختيار الأول، والآخر معتق بلازم الاختيار، فكأنه معتق على القصد الثاني، ومشترٍ على القصد الأول، والآخر بالعكس.
واختلف مالك والشافعي في من أعتق نصفي عبدين:
فقال مالك[76]: لا يجوز ذلك.
وقال الشافعي[77]: يجوز؛ لأنه في معنى الواحد.
ومالك تمسك بظاهر دلالة اللفظ، فهذا ما اختلفوا فيه من شروط الرقبة المعتقة.
وأما شروط الإطعام: فإنهم اختلفوا من ذلك في القدر الذي يجزئ لمسكين مسكين من الستين مسكينًا الذين وقع عليهم النص.
عن مالك[78] في ذلك روايتان:
أشهرهما: أن ذلك مُد بمُد هشام لكل واحد، وذلك مُدَّان بمُدِّ النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قيل: هو أقل، وقد قيل: هو مُد وثلث.
وأما الرواية الثانية: فمدٌّ مدٌّ لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال الشافعي[79].
فوجه الرواية الأولى: اعتبار الشبع غالبًا، أعني: الغداء والعشاء. ووجه هذه الرواية الثانية: اعتبار هذه الكفارة [بكفارة] اليمين.
فهذا هو اختلافهم في شروط الصحة في الواجبات في هذه الكفارة.
وأما اختلافهم في مواضع تعددها، ومواضع اتحادها:
فمنها: إذا ظاهر بكلمة واحدة من نسوة أكثر من واحدة، هل يجزئ في ذلك كفارة واحدة أم يكون عدد الكفارات على عدد النسوة؟
فعند مالك[80]: أنه يجزئ في ذلك كفارة واحدة.
وعند الشافعي[81] وأبي حنيفة[82]: أن فيها من الكفارات بعدد المظاهر منهن، إن اثنتين فاثنتين، وإن ثلاثًا فثلاثًا، وإن أكثر [فأكثر]، فمن شبهه بالطلاق أوجب في كل واحدة كفارة، ومن شبهه بالإيلاء أوجب فيه كفارة واحدة، وهو بالإيلاء أشبه.
ومنها: إذا ظاهر من امرأته في مجالس شتى، هل عليه كفارة واحدة أو على عدد المواضع التي ظاهر فيها؟
فقال مالك[83]: ليس عليه إلا كفارة واحدة إلا أن يظاهر [فلم يكفر][84]، ثم يظاهر فعليه كفارة ثانية، وبه قال الأوزاعي، وأحمد[85]، وإسحاق.
وقال أبو حنيفة[86] والشافعي[87]: لكل ظِهار كفارة.
وأما إذا كان ذلك في مجلس واحد، فلا خلاف عند مالك أن في ذلك كفارة واحدة.
وعند أبي حنيفة[88]: أن ذلك راجع إلى نيته، فإن قصد التأكيد كانت الكفارة واحدة، وإذا أراد استئناف الظِّهار كان ما أراد، ولزمه من الكفارات على عدد الظِّهار.
وقال يحيى بن سعيد: تلزم الكفارة على عدد الظِّهار سواءٌ كان في مجلس واحد أو في مجالس شتى.
والسبب في هذا الاختلاف: أن الظِّهار الواحد بالحقيقة هو الذي يكون بلفظ واحد من امرأة واحدة في وقت واحد.
والمتعدد بلا خلاف: هو الذي يكون بلفظين من امرأتين في وقتين، فإن كرَّر اللفظ من امرأة واحدة، فهل يوجب تعدد اللفظ تعدد الظِّهار أم لا يوجب ذلك فيه تعددًا؟
وكذلك إن كان اللفظ واحدًا والمظاهر منها أكثر من واحدة؟ وذلك أن هذه بمنزلة المتوسطات بين ذينك الطرفين، فمن غلب عليه شبه الطرف الواحد أوجب له حكمه، ومن أوجب[89] عليه شبه الطرف الثاني أوجب له حكمه.
ومنها: إذا ظاهر من امرأته، ثم مسها قبل أن يُكفِّر، هل عليه كفارة واحدة أم لا؟
فأكثر فقهاء الأمصار مالك[90]، والشافعي[91]، وأبو حنفية[92]، والثوري، والأوزاعي، وأحمد[93]، وإسحاق، وأبو ثور، وداود[94]، والطبري، وأبو عبيد، أن في ذلك كفارة واحدة.
والحجة لهم حديث سلمة بن صخر البياضي أنه ظاهر من امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وقع بامرأته قبل أن يكفر، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فأمره أن يُكفر تكفيرًا واحدًا[95].
وقال قومٌ: عليه كفَّارتان: كفَّارة العزم على الوطء، وكفارة الوطء؛ لأنه وطئ وطًأ محرمًا، وهو مروي عن عمرو بن العاص[96]، وقبيصة بن ذؤيب[97]، وسعيد بن جبير[98]، وابن شهاب[99].
وقد قيل: إنه لا يلزمه شيء، لا عن العود ولا عن الوطء؛ لأن الله تعالى اشترط صحة الكفارة قبل المسيس، فإذا مس فقد خرج وقتها، فلا تجب إلا بأمر مجدد؛ وذلك معدوم في مسألتنا، وفيه شذوذ.
وقال أبو محمد بن حزم[100]: من كان فرضه الإطعام فليس يحرم عليه المسيس قبل الإطعام، وإنما يحرم المسيس على من كان فرضه العتق أو الصيام"[101].
وقال ابن رشد أيضًا: "وأما هل يدخل الإيلاء على الظِّهار إذا كان مضارًا، وذلك بألا يكفر مع قدرته على الكفارة؟ فإن فيه أيضًا اختلافًا:
فأبو حنيفة[102] والشافعي[103] يقولان: لا يتداخل الحكمان؛ لأن حكم الظِّهار خلاف حكم الإيلاء، وسواء كان عندهم مضارًا أو لم يكن، وبه قال الأوزاعي وأحمد[104] وجماعة.
وقال مالك[105]: يدخل الإيلاء على الظِّهار بشرط أن يكون مضارًا.
وقال الثوري: يدخل الإيلاء على الظِّهار، وتبين منه بانقضاء الأربعة الأشهر من غير اعتبار المضارة، ففيه ثلاثة أقوال:
قول: إنه يدخل بإطلاق.
وقول: إنه لا يدخل بإطلاق.
وقول: إنه يدخل مع المضارة، ولا يدخل مع عدمها.
وسبب الخلاف: مراعاة المعنى واعتبار الظاهر، فمن اعتبر الظاهر قال: لا يتداخلان، ومن اعتبر المعنى قال: يتداخلان إذا كان القصد الضرر"[106].
وقال في "الاختيارات": "وما يخرج في الكفارة المطلقة غير مقيد بالشرع بل بالعُرف قدرًا ونوعًا، من غير تقدير ولا تمليك، وهو قياس المذهب في الزوجة والأقارب، والمملوك، والضيف، والأجير المستأجر بطعامه، والإدام يجب إن كان يطعم أهله بإدام وإلا فلا.
وعادة الناس تختلف في ذلك في الرُّخْص والغلاء واليسار والإعسار، وتختلف بالشتاء والصيف.
والواجبات المقدرات في الشرع من الصدقات على ثلاثة أنواع:
تارة: تقدَّر الصدقة الواجبة، ولا يقدر من يعطاها كالزكاة .
وتارة: يقدَّر المُعطى، ولا يقدر المال كالكفارات.
وتارة: يقدر هذا وهذا كفدية الأذى؛ وذلك أن سبب وجوب الزكاة هو المال، فقَدَّر [فيها] المال الواجب.
وأما الكفارات: فسببها فعل بدنه كالجماع واليمين والظِّهار، فقدر فيها المعطى كما قُدر العتق والصيام، وما يتعلق بالحج فيه بدن ومال فهو عبادة بدنية ومالية؛ فلهذا قدر فيه هذا وهذا"[107].
وقال الشوكاني في "الدرر البهية": "باب الظهار: هو قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، أو: ظاهرتك، أو نحو ذلك، فيجب عليه قبل أن يمسها أن يكفر بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وإن لم يستطع فليطعم ستين مسكينًا.
ويجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيرًا لا يقدر على الصوم، وله أن يصرف منها لنفسه وعياله، وإذا كان الظِّهار مؤقتًا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت، وإذا وطئ قبل انقضاء الوقت -أو قبل التكفير – كفَّ حتى يكفر في المُطْلق، وينقضي وقت المؤقَّت"[108].
الإسلام: هو المنهج الذي وضعه الله سبحانه وتعالى للناس كي يستقيموا عليه، وتكون حياتهم مبنيةً عليه، والذي بيَّنه رسوله -صلى الله عليه وسلّم- لهم، وإنّ للإسلام مجموعة من المبادئ والأُسس التي يجب على الإنسان حتى يكون مسلماً بحق الالتزام بها وهي اركان الإسلام. الإسلام دين التَّوحيد، فالإيمان والاعتقاد الجازم بوجود خالقٍ واحدٍ مدّبرٍ لهذا العالم؛ يجعل منه ديناً تقبله العقول المُفكِّرة؛ فالإسلام يُنظِّم الحياة البشريّة في أيّ مجتمعٍ في مختلف الميادين الاقتصاديّة، والسِّياسيّة، والثَّقافيّة، والإجتماعيّة. جاء الإسلام ليكون خاتمة الأديان السّماويّة؛ فجاء بتعاليم سمحةٍ وقابلةٍ للتّطبيق في أيّ زمانٍ ومكانٍ على المجتمعات العربيّة وغير العربيّة، فأولى الإسلام في تعاليمه ومبادئه اهتماماً كبيراً بالمجتمع وقبله الأُسرة؛ فمجموع الأُسر الصّالحة هو مجتمعٌ صالحٌ قادرٌ على مواجهة التَّحديات الدَّاخليّة والخارجيّة. الإسلام وبناء المجتمع.
- ما هي اهمية الدين في حياتنا ؟ لماذا علينا تعلم اصل ديننا الإسلامي ؟ ما مدى احتياجنا للدين والإسلام ؟
خلق الله عزوجل الإنسان وكرّمه عن سائر المخلوقات بأن خلقه في أحسن تقويم، وأعطاه العقل الذي هو بمثابة القوّة التي تحرّكه، فالعقل هو تلك الأداة التي يفكّر ويتفكّر بها الإنسان ليحقّق الغاية التي خُلق من أجلها ألا وهي عمارة الأرض، فالإنسان هو المخلوق الوحيد الذي كلّفه جل وعلا بعمارة الأرض، إلا أنّه سبحانه وتعالى لم يترك الإنسان هائماً على وجهه في هذا العالم بل جعل له منظومة من العقائد، والمفاهيم، والأحكام، والأخلاق والتي تندرج جميعها تحت الدين، فالدين هو الذي ينظّم حياة الإنسان ويجعله يحقّق الغاية من خلقه، فأيّ إنسان على وجه الأرض لا يستطيع أن يعيش دون وجود الدين، فحاجة البشريّة إلى الدين كحاجة الأرض إلى الماء، فهو بالنسبة لهم أهمّ من أيّ شيء في هذه الحياة.
والدين هو الفطرة التي يفطر الله عزوجل الناس عليها منذ أن يولدوا من بطون أمهاتهم كما جاء في قول رسولنا الكريم : " كل مولود يولد على الفطرة "، ومن هنا ظهرت حاجة الإنسان الفطريّة إلى الدين، أي إنّه في وقت الشدائد والمصائب يجد نفسه لا إراديّاً يطلب العون والغوث من قوّة مطلقة عليا لديها القدرة وحدها على إخراجه مما ألم به من مصائب الدنيا، لذا جاء القرآن الكريم ليبين لنا أن الله عزوجل وحده هو القادر على فعل كل شيء وهو وحده القادر على إخراجنا من أيّ من المشاكل والملمّات التي نمر بها، كما جاء في الآية الكريمة : "وإذا مسّ الناس ضرٌّ دعوا ربهم منيبين إليه، ثمّ إذا أذاقهم منه رحمة، إذا فريقٌ منهم بربهم يشركون"(الروم:33).
الإنسان بطبعه دائم التفكّر في كل ما يجري في هذا وفي كيفيّة نشأته وإلى أين سيكون مصيره بعد الموت، ممّا جعله في حيرة دائمة حيال تلك الأمور، لذا جاء الدين ليعرّف الإنسان بقدرة الله عزوجل على خلق هذا الكون وكل ما فيه، وقد اهتمّ الدين اهتماماً كبيراً بالجانب العلميّ من الحياة، فقد جاء ليعلم الإنسان ما يحدث في واقعه وأنّه جزء لا يتجزّأ من هذا الكون الواسع الذي يعيش فيه، كما عرفه بالمصير الذي سيؤول إليه بعد موته، وأنّه ليس هنالك أيّ شيء خالد في هذا الكون إلا الله عزوجل وحده، كما قال سبحانه : "كل من عليها فان، ويبقى وجه ربّك ذو الجلال والإكرام"(الرحمن:26، 27).
تكمن أهمّيّة الدين بأنّه جاء بمثابة الوحي الذي يهدي عقولنا إلى الطريق القويم، وبالتالي استقامة النفس واستقرارها وابتعادها عن كلّ ما يسبّب لها الاضطراب والجزع، كما أنّه مهمّ جدّاً لحياة المجتمع فهو الذي يضمن تحقيق العدل والمساواة بين الناس، فيجعل الناس يلجؤون إليه فيه كل أمور حياتهم، ليكون هو مصدر القوّة الذي يستندون إليه ويحتمون به، ممّا يجعل المسلم صابراً وممتثلاً لأمر الله، لإيمانه ويقينه بقدرة الله عزوجل.
الدين هو الذي يجعل الإنسان يقوم بكل ما يأمره به الله عزوجل من عبادات وطاعات لتوصله إلى الطريق المؤدّي إلى رضاه جلّ وعلا، وإلى جنان الخلد التي وعد بها سبحانه وتعالى عباده المؤمنين الطائعين، كما جاء في الذكر الحكيم : "ومن يعمل من الصالحات من ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنّة ولا يظلمون نقيرا"، كما أنّه الذي يجعل الفرد مستشعراً لمراقبة الله سبحانه وتعالى له، وبالتالي يعزّز لديه الشعور بالمسؤوليّة تجاه ربّه ونفسه ومجتمعه، فيهذّب النفس ويزجرها عن الوقوع في الملذات والشهوات المحرمة، ويوقظ ضميره للسير على الطريق الصحيح والسليم الذي يتفّق وفطرته التي فطره الله عزوجل عليها، وصلاح الدين يعني صلاح الدنيا والآخرة للإنسان، فقد كان رسولنا الكريم يدعو دائماً : " اللهمّ أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري".
كيف يجعل الإسلام حياتنا افضل وينظم جميع جوانبها ؟
ركزّ الإسلام في بناء المجتمع المُسلم على الفرد المسلم أولًا ثُم الأُسرة، ثُمّ المجتمع،وبنى علاقاتٍ تبادليّةٍ بين هؤلاء الأطراف؛ فجعل لكلّ واحدٍ منهم حقوقٌ وواجباتٌ من خلال:
• تأكيد روح التّساوي والأخوة بين المسلمين،
فالإسلام يُنكر وينهى عن العصبيّة والفوارق على أساس العِرق واللَّون والنّسب التي تُدمر المجتمع،
وجعل معيار التّفاضل بالتّقوى والصّلاح، قال تعالى:"إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم".
• الإسلام يسعى إلى تنظيم المجتمع من خلال تنظيم حياة الفرد المُسلم،
والعنصر الرئيسيّ في ذلك هو تنظيم الوقت واستغلاله في العمل والعبادة ومساعدة الآخرين وفعل الخير.
• دعوة الإسلام إلى العمل وترك الكسل والتّواكل؛
فالمجتمع يُبنى بالعمل الدَّؤوب المنتظم في مؤسساتٍ وأعمالٍ فرديّةٍ،
كي تعود بالنّفع على الفرد المسلم وعائلته فيلبون احتياجاتهم الخاصّة،
كما بالعمل تُقللّ الأعباء الواقعة على كاهل المجتمع نتيجة البطالة وارتفاع
معدّل الفقر وبالتالي الجريمة والانحراف السُّلوكيّ والأخلاقيّ.
• الإسلام يدعو كافّة أبناء المجتمع المسلم في مختلف الأعمار
إلى طلب العلم والتَّطور والبحث العلميّ في كافّة المجالات؛
فالإسلام دين العلم والنُّور والهداية،
فالمسلمون كانوا في القرون الوسطى مشاعل العلم في مختلف العلوم العصريّة؛
فبرز العديد من العلماء الأجلاء كابن الهيثم، والبيروني، وابن سينا وغيرهم.
• حددّ الإسلام مواثيق هامّة في المجتمع أهمها ميثاق الزَّواج
ليكون الإطار الشّرعيّ لعلاقة الرَّجل بالمرأة، ثُمّ حددّ حقوقاً وواجبات كُلِّ طرفٍ،
ثُمّ حددّ حقوق الأبناء على والديهم وبالعكس؛
وكلُّ ذلك لبناء الأُسرة الصّالحة العفيفة الشّرعيّة التي يسودها الحب والسّكينة؛
فتكون قادرةً على تنشئة الأبناء تنشئةً صالحةً ممّا ينعكس أثرها على المجتمع.
• حددّ الإسلام وبشكلٍ دقيق طبيعة العلاقات بين النّاس وحقّ كلِّ فردٍ وواجبه؛
فحددّ أحكام البيوع والتجارة والزواج والطلاق،
وأحكام الجوار، وأحكام القضاء، والقَصاص، والعقوبات، وأحكام الحاكم والمحكوم.
• ندب الإسلام الشّباب وأصحاب الأموال إلى المساهمة في بناء المجتمع
من خلال العمل الخيريّ والتَّطوعيّ، سواءً بالعمل الميدانيّ،
وتقديم العون للنّاس أو بدفع الصّدقات والتّبرعات النَّقديّة والعينيّة لمن يُساهم في إفادة المجتمع منها.
الكفارات أحكام وضوابط
الكفارات ( أحكام ــ وضوابط )
تأليف الدكتور/ عبدالرقيب صالح الشامي
رقم الإيداع بمرگز التخطيط والمعلومات
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
2018/2 م
حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
1439 ه - 2018 م
فهرست مگتبة الگويت الوطنية
1813 - رقم الإيداع والترقيم الدولي: 2017
ISBN: 978 - 99966 - 986 - 7 - 5
نبذة عن موضوع الكتاب :
قوله: "ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضررًا بينًا..." إلى قوله: "ولا يجزئ من البُرِّ أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين، وإن غدَّى المساكين أو عشَّاهم لم يجزئه"[1].
قال في "المقنع": "والمخرج في الكفَّارة ما يجزئ في الفِطرة وفي الخبز روايتان[2]، فإن كان قوت بلده غير ذلك أجزأه منه؛ لقول الله تعالى: ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ [المائدة: 89].
وقال القاضي: لا يجزئه، ولا يجزئ من البُر أقل من مُدٍّ، ولا من غيره أقل من مدين، ولا من الخبز أقل من رطلين بالعراقي إلا أن يعلم أنه مد، وإن أخرج القيمة أو غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه[3]، وعنه[4]: يجزئه"[5].
قال في "الحاشية": "قوله: "والمخرج في الكفارة ما يجزئ في الفطرة" وهو البر والشعير والتمر والزبيب ونحوها، سواء كان قوت بلده أو لم يكن، وإخراج الحب[6] أفضل عند المصنف، والمذهب[7] أن التمر أفضل.
قوله: "وفي الخبز روايتان".
إحداهما[8]: لا يجزئ وهو المذهب، وبه قال الشافعي[9]؛ لأنه خرج عن الكمال والادخار أشبه الهريسة.
والثانية[10]: يجزئ، اختاره الخرقي، والقاضي وأصحابه، والمصنف.
قال في "الإنصاف"[11]: وهو الصواب؛ لقوله تعالى: ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾، والخبز من أوسط ما يطعم أهله.
فائدتان:
الأولى: السويق كالخبز خلافًا ومذهبًا.
الثانية: لا تجزئ الهريسة ونحوها؛ لخروجها عن الاقتيات المعتاد إلى حيز الإدام.
قوله: "فإن كان قوت بلده غير ذلك أجزأه منه؛ لقول الله تعالى: ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾، وبه قال الشافعي[12]، واختاره ابو الخطاب. والمصنف، قال في "الإنصاف": وهو الصواب[13].
وقال القاضي: لا يجزئه وهو المذهب[14]؛ لأن الخبر ورد بإخراج هذه الأصناف في الفطرة، فلم يجز غيره.
قوله: "ولا يجزئ من البر أقل من مد..." إلى آخره، هذا المذهب[15].
وممن قال: مدُّ بُر: زيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر[16] رواه عنهم الأثرم، وعن عطاء، وسليمان بن موسى، وقال سليمان بن يسار: أدركتُ الناس إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مُدًا من الحنطة بالمد الأصغر مُد النبي صلى الله عليه وسلم[17].
وقال أبو هريرة: يطعم مدًا من أي الأنواع كان، وبه قال عطاء، والأوزاعي، والشافعي[18]؛ لما روى أبو داود بإسناده عن أوس ابن أخي عبادة بن الصامت: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه - يعني المظاهر - خمسة عشر صاعًا من شعير إطعام ستين مسكينًا[19].
وقال مالك[20]: لكل مسكين مُدان من جميع الأنواع.
وممن قال: مُدَّان من قمح: مجاهد[21]، وعكرمة، والشعبي[22]، والنخعي[23].
وقال الثوري وأصحاب الرأي[24]: من القمح مُدَّان، ومن التمر والشعير صاع لكل مسكين؛ لقوله عليه السلام في حديث سلمة بن صخر: "فأطعم وسقًا من تمر" رواه أحمد وأبو داود وغيرهما[25].
وعن ابن عباس قال: كفَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر الناس، فمن لم يجد فنصف صاع من بُر. رواه ابن ماجه[26].
ولنا ما روى أحمد: حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب عن أبي يزيد المدني قال: جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمظاهر: "أطعم هذا؛ فإن مدي شعير مكان مدِّ بُر"[27]، وهذا مرسل؛ لأن أبا يزيد تابعي، ولأنه قول زيد وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة، ولم نعرف لهم من الصحابة مخالفًا فكان إجماعًا.
وعلى أنه نصف صاع من التمر والشعير ما في حديث أوس بن الصامت أنه عليه السلام قال: "إني سأعينه بعرق من تمر"، قلت: يا رسول الله، فإني سأعينه بعرق آخر، قال: "أحسنت، اذهبي فأطعمي عنه ستين مسكينًا، وارجعي إلى ابن عمك"[28].
روى أبو داود عن أبي سلمة أنه قال: العرق زنبيل يأخذ خمسة عشر صاعًا، فالعرقان ثلاثون صاعًا، لكل مسكين نصف صاع[29].
وأوجب الشيخ تقي الدين أوسطه قدرًا ونوعًا مطلقًا بلا تقدير.
قوله: "وإن أخرج القيمة..." إلى آخره، فيه مسألتان:
الأولى: إذا أخرج القيمة لم يجزئه وهو المذهب[30]، وبه قال مالك[31]، والشافعي[32]، وابن المنذر[33]، وهو الظاهر من قول عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما.
وأجازه الأوزاعي وأصحاب الرأي[34]، والأول المذهب[35] للآية، ومن أخرج القيمة لم يطعمهم.
الثانية: إذا غدَّى المساكين أو عشاهم لم يجزئه، وهو المذهب[36] سواء فعل ذلك بالقدر الواجب أو أقل أو أكثر، ولو غدى كل واحد بمُد لم يجزئه إلا أن يُملكه إياه، وهذا مذهب الشافعي[37].
وعن أحمد[38]: يجزئه إذا أطعمهم القدر الواجب لهم، وهو قول النخعي وأبي حنيفة[39]، واختاره الشيخ تقي الدين[40] إلا أنه لم يعتبر القدر الواجب، وأطعم أنس في فدية الصيام.
قال أحمد: أطعِم شيئًا كثيرًا وضع الجفان، وذلك لقول الله تعالى ﴿ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ﴾، وهذا قد أطعمهم، فينبغي أن يجزئه كما لو ملكهم[41]" .
وقال ابن رشد: "والنظر في كفارة الظهار في أشياء:
منها: في عدد أنواع الكفارة وترتيبها وشروط كل نوع منها - أعني: الشروط المصححة- ومتى تجب كفارة واحدة؟ ومتى تجب أكثر من واحدة؟
فأما أنواعها: فإنهم أجمعوا على أنها ثلاثة أنواع: إعتاق رقبة، أو صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينًا[42].
وأنها على الترتيب، فالإعتاق أولًا، فإن لم يكن فالصيام، فإن لم يكن فالإطعام، هذا في الحُرِّ.
واختلفوا في العبد: هل يكفر بالعتق أو الإطعام؟ بعد اتفاقهم أن الذي يبدأ به الصيام -أعني: إذا عجز عن الصيام- فأجاز للعبد العتق إن أذن له سيده: أبو ثور وداود[43]، وأبى ذلك سائر العلماء.
وأما الإطعام فأجازه له مالك[44] إن أطعم بإذن سيده، ولم يجز ذلك أبو حنيفة[45] والشافعي[46].
ومبنى الخلاف في هذه المسألة: هل يملك العبد أو لا يملك؟
وأما اختلافهم في الشروط المصححة فمنها: اختلافهم إذا وطئ في صيام الشهرين، هل عليه استئناف الصيام أم لا؟
فقال مالك[47] وأبو حنيفة[48]: يستأنف الصيام إلا أن أبا حنيفة شرط في ذلك العمد، ولم يفرق مالك بين العمد في ذلك والنسيان.
وقال الشافعي[49]: لا يستأنف على حال.
وسبب الخلاف: تشبيه كفارة الظهار بكفارة اليمين، والشرط الذي ورد في كفارة الظهار -أعني: أن تكون قبل المسيس- فمن اعتبر هذا الشرط قال: يستأنف الصوم، ومن شبهه بكفارة اليمين قال: لا يستأنف؛ لأن الكفارة في اليمين ترفع الحنث بعد وقوعه باتفاق[50].
ومنها: هل من شرط الرقبة أن تكون مؤمنة أم لا؟
فذهب مالك[51] والشافعي[52]: إلى أن ذلك شرط في الإجزاء.
وقال أبو حنيفة[53]: يجزئ في ذلك رقبة الكافر، ولا يجزئ عندهم إعتاق الوثنية والمرتدة.
دليل الفريق الأول: أنه إعتاق على وجه القربة، فوجب أن تكون مسلمة، وأصله الإعتاق في كفارة القتل.
وربما قالوا: إن هذا [ليس] من باب القياس، وإنما هو من باب حمل المطلق على المقيد، وذلك أنه قيَّد الرقبة بالإيمان في كفارة القتل، وأطلقها في كفارة الظِّهار، فيجب صرف المطلق إلى المقيد، وهذا النوع من حمل المطلق على المقيد فيه خلاف، والحنفية لا يجيزونه، وذلك أن الأسباب في القضيتين مختلفة.
وأما حجة أبي حنيفة: فهو ظاهر العموم، ولا معارضة عنده بين المطلق والمقيد، فوجب عنده أن يحمل كل على لفظه.
وأما حجة أبي حنيفة: فهو ظاهر العموم، ولا معارضة عنده بين المطلق والمقيد، فوجب عنده أن يحمل كل على لفظه.
ومنها: اختلافهم هل من شرط الرقبة أن تكون سالمة من العيوب أم لا؟ ثم إن كانت سليمة، فمِن أي العيوب تشترط سلامتها؟
فالذي عليه الجمهور[54] أن للعيوب تأثيرًا في منع إجزاء العتق.
وذهب قوم إلى أنها ليس لها تأثير في ذلك.
وحجة الجمهور: تشبيهها بالأضاحي والهدايا؛ لكون القُربة تجمعها.
وحجة الفريق الثاني: إطلاق اللفظ في الآية، فسبب الخلاف: معارضة الظاهر لقياس الشبه.
والذين قالوا: إن للعيوب تأثيرًا في مَنع الإجزاء، اختلفوا في عيب عيب مما يعتبر في الإجزاء أو عدمه.
أما العمى وقطع اليدين أو الرِّجلين فلا خلاف عندهم في أنه مانع للإجزاء، واختلفوا فيما دون ذلك، فمنها: هل يجوز قطع اليد الواحدة؟
أجازه أبو حنيفة[55]. ومنعه مالك[56] والشافعي[57].
وأما الأعور:
فقال مالك[58]: لا يجزئ.
وقال عبد الملك: يجزئ.
وأما الأقطع الأذن:
فقال مالك[59]: لا يجزئ.
وقال أصحاب الشافعي[60]: يجزئ.
وأما الأصم: فاختلف فيه في مذهب مالك، فقيل[61]: يجزئ، وقيل[62]: لا يجزئ.
وأما الأخرس: فلا يجزئ عند مالك[63]، وعن الشافعي في ذلك قولان[64].
أما المجنون: فلا يجزئ.
أما الخصي: فقال ابن القاسم[65]: لا يعجبني الخصي.
وقال غيره: لا يجزئ.
وقال الشافعي[66]: يجزئ.
وإعتاق الصغير جائز في قول عامة فقهاء الأمصار، وحُكي عن بعض المتقدمين منعه.
والعرج الخفيف في المذهب[67] يجزئ.
وأما البيِّن العرج فلا.
والسبب في اختلافهم: اختلافهم في قدر النقص المؤثر في القربة، وليس له أصل في الشرع إلا الضحايا، وكذلك لا يجزئ في المذهب[68] ما فيه شركة أو طرف حرية كالكتابة والتدبير؛ لقوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [المجادلة: 3] والتحرير هو ابتداء الإعتاق، وإذا كان فيه عقد من عقود الحرية كالكتابة كان تنجيزًا لا إعتاقًا، وكذلك الشركة؛ لأن بعض الرقبة ليس برقبة.
وقال أبو حنيفة[69]: إن كان المكاتب أدَّى شيئًا من مال الكتابة لم يجز، وإن كان لم يؤد جاز.
واختلفوا هل يجزئه عتق مدبره؟.
فقال مالك[70]: لا يجزئه، تشبيهًا بالكتابة؛ لأنه عقد ليس حله.
وقال الشافعي[71]: يجزئه.
ولا يجزئ عند مالك[72] إعتاق أم ولده، ولا المعتق إلى أجل مسمى. أما عتق أم الولد؛ فلأن عقدها آكد من عقد الكتابة والتدبير بدليل أنهما قد يطرأ عليهما الفسخ، أما في الكتابة: فمن العجز عن أداء النجوم.
وأما في التدبير: فإذا ضاق عنه الثلث.
وأما العتق إلى أجل: فإنه عقد عتق لا سبيل إلى حلّه.
واختلف مالك والشافعي مع أبي حنيفة في إجزاء عتق من يعتق عليه بالنسب:
فقال مالك[73] والشافعي[74]: لا يجزئ عنه.
وقال أبو حنيفة[75]: إذا نوى به عتقه عن ظِهار أجزأ.
فأبو حنيفة شبهه بالرقبة التي لا يجب عتقها، وذلك أن كل واحدة من رقبتين غير واجب عليه شراؤها، وبذل القيمة فيها على وجه العتق، فإذا نوى بذلك التكفير جاز.
والمالكيةُ والشافعيةُ رأت أنه إذا اشترى من يعتق عليه عتق عليه من غير قصد إلى إعتاقه فلا يجزئه.
فأبو حنيفة أقام القصد للشراء مقام العتق، وهؤلاء قالوا: لا بُد أن يكون قاصدًا للعتق نفسه، فكلاهما يسمى معتقًا باختياره، ولكن أحدهما معتق بالاختيار الأول، والآخر معتق بلازم الاختيار، فكأنه معتق على القصد الثاني، ومشترٍ على القصد الأول، والآخر بالعكس.
واختلف مالك والشافعي في من أعتق نصفي عبدين:
فقال مالك[76]: لا يجوز ذلك.
وقال الشافعي[77]: يجوز؛ لأنه في معنى الواحد.
ومالك تمسك بظاهر دلالة اللفظ، فهذا ما اختلفوا فيه من شروط الرقبة المعتقة.
وأما شروط الإطعام: فإنهم اختلفوا من ذلك في القدر الذي يجزئ لمسكين مسكين من الستين مسكينًا الذين وقع عليهم النص.
عن مالك[78] في ذلك روايتان:
أشهرهما: أن ذلك مُد بمُد هشام لكل واحد، وذلك مُدَّان بمُدِّ النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قيل: هو أقل، وقد قيل: هو مُد وثلث.
وأما الرواية الثانية: فمدٌّ مدٌّ لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال الشافعي[79].
فوجه الرواية الأولى: اعتبار الشبع غالبًا، أعني: الغداء والعشاء. ووجه هذه الرواية الثانية: اعتبار هذه الكفارة [بكفارة] اليمين.
فهذا هو اختلافهم في شروط الصحة في الواجبات في هذه الكفارة.
وأما اختلافهم في مواضع تعددها، ومواضع اتحادها:
فمنها: إذا ظاهر بكلمة واحدة من نسوة أكثر من واحدة، هل يجزئ في ذلك كفارة واحدة أم يكون عدد الكفارات على عدد النسوة؟
فعند مالك[80]: أنه يجزئ في ذلك كفارة واحدة.
وعند الشافعي[81] وأبي حنيفة[82]: أن فيها من الكفارات بعدد المظاهر منهن، إن اثنتين فاثنتين، وإن ثلاثًا فثلاثًا، وإن أكثر [فأكثر]، فمن شبهه بالطلاق أوجب في كل واحدة كفارة، ومن شبهه بالإيلاء أوجب فيه كفارة واحدة، وهو بالإيلاء أشبه.
ومنها: إذا ظاهر من امرأته في مجالس شتى، هل عليه كفارة واحدة أو على عدد المواضع التي ظاهر فيها؟
فقال مالك[83]: ليس عليه إلا كفارة واحدة إلا أن يظاهر [فلم يكفر][84]، ثم يظاهر فعليه كفارة ثانية، وبه قال الأوزاعي، وأحمد[85]، وإسحاق.
وقال أبو حنيفة[86] والشافعي[87]: لكل ظِهار كفارة.
وأما إذا كان ذلك في مجلس واحد، فلا خلاف عند مالك أن في ذلك كفارة واحدة.
وعند أبي حنيفة[88]: أن ذلك راجع إلى نيته، فإن قصد التأكيد كانت الكفارة واحدة، وإذا أراد استئناف الظِّهار كان ما أراد، ولزمه من الكفارات على عدد الظِّهار.
وقال يحيى بن سعيد: تلزم الكفارة على عدد الظِّهار سواءٌ كان في مجلس واحد أو في مجالس شتى.
والسبب في هذا الاختلاف: أن الظِّهار الواحد بالحقيقة هو الذي يكون بلفظ واحد من امرأة واحدة في وقت واحد.
والمتعدد بلا خلاف: هو الذي يكون بلفظين من امرأتين في وقتين، فإن كرَّر اللفظ من امرأة واحدة، فهل يوجب تعدد اللفظ تعدد الظِّهار أم لا يوجب ذلك فيه تعددًا؟
وكذلك إن كان اللفظ واحدًا والمظاهر منها أكثر من واحدة؟ وذلك أن هذه بمنزلة المتوسطات بين ذينك الطرفين، فمن غلب عليه شبه الطرف الواحد أوجب له حكمه، ومن أوجب[89] عليه شبه الطرف الثاني أوجب له حكمه.
ومنها: إذا ظاهر من امرأته، ثم مسها قبل أن يُكفِّر، هل عليه كفارة واحدة أم لا؟
فأكثر فقهاء الأمصار مالك[90]، والشافعي[91]، وأبو حنفية[92]، والثوري، والأوزاعي، وأحمد[93]، وإسحاق، وأبو ثور، وداود[94]، والطبري، وأبو عبيد، أن في ذلك كفارة واحدة.
والحجة لهم حديث سلمة
 مهلاً !
مهلاً !قبل تحميل الكتاب .. يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'تحميل البرنامج'

نوع الكتاب : pdf.
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني و يمكنك تحميله من هنا:


كتب اخرى في كتب الفقه العام

نهاية المطلب في دراية المذهب الجزء السابع عشر PDF
قراءة و تحميل كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب الجزء السابع عشر PDF مجانا

نهاية المطلب في دراية المذهب الجزء الثامن عشر PDF
قراءة و تحميل كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب الجزء الثامن عشر PDF مجانا

نهاية المطلب في دراية المذهب الجزء التاسع عشر PDF
قراءة و تحميل كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب الجزء التاسع عشر PDF مجانا

نهاية المطلب في دراية المذهب الجزء العشرون PDF
قراءة و تحميل كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب الجزء العشرون PDF مجانا
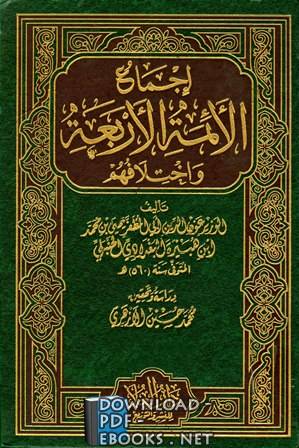
إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم (ت: الأزهري) المجلد الثاني: الرهن - الإقرار * 1259 - 2499 PDF
قراءة و تحميل كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم (ت: الأزهري) المجلد الثاني: الرهن - الإقرار * 1259 - 2499 PDF مجانا
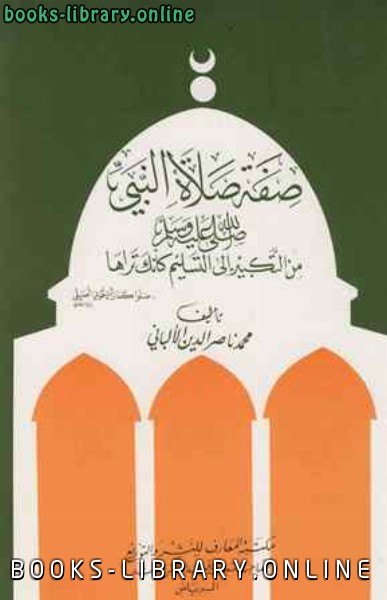
صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك تراها PDF
قراءة و تحميل كتاب صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك تراها PDF مجانا
الفقه الإسلامي الميسر وأدلته الشرعية PDF
قراءة و تحميل كتاب الفقه الإسلامي الميسر وأدلته الشرعية PDF مجانا